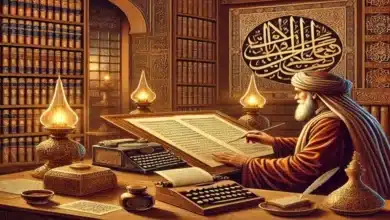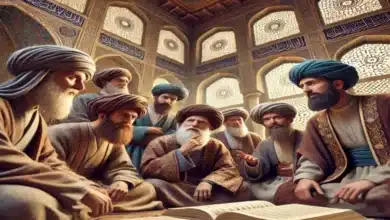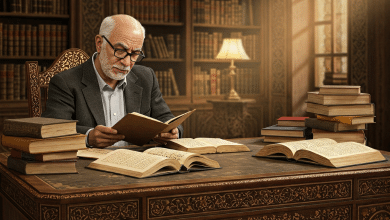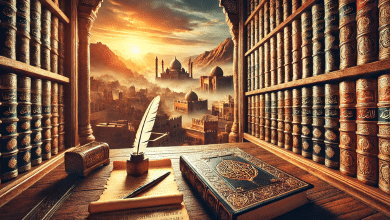قدامة بن جعفر رائد التنظير النقدي في العصر العباسي

جمع قدامة بن جعفر رائدٌ بين البلاغة والمنطق ليحوّل النقد من ذوق عابر إلى منهج علميّ يُقاس ويُحلَّل. حيث رسّخ تعريفًا للشعر يضمّ الوزن والقافية والدلالة، ووازن بين اللفظ والمعنى بوحدةٍ بنائيّة متماسكة أثّرت في اللاحقين. وواصل مشروعه عبر كتب صاغت معايير للجودة والرداءة، وربطت الجمال بوظيفته الفكرية لا بالزينة اللفظية وحدها. وبدورنا سنستعرض بهذا المقال ملامح منهجه العقلي، وتعريفه للشعر، وصلته بالجمال والبلاغة، وأثره في المدارس النقدية بعده.
محتويات
- 1 قدامة بن جعفر رائد النقد الأدبي في العصر العباسي
- 2 مفهوم النقد عند قدامة بن جعفر وأهم إضافاته النظرية
- 3 ما الذي جعل قدامة بن جعفر يتفوق على معاصريه؟
- 4 أهم مؤلفات قدامة بن جعفر في التنظير النقدي
- 5 التحليل الأسلوبي واللغوي في فكر قدامة بن جعفر
- 6 كيف ساهم قدامة بن جعفر في تأسيس علم الجمال الأدبي؟
- 7 أثر قدامة بن جعفر في النقد العربي اللاحق
- 8 مكانة قدامة بن جعفر في تاريخ النقد الأدبي العربي
- 9 ما الجديد الذي أضافه قدامة لتعريف الشعر؟
- 10 كيف ربط بين البلاغة والمنطق في الممارسة النقدية؟
- 11 ما أثر مشروعه في النقاد اللاحقين والدرس الأكاديمي؟
قدامة بن جعفر رائد النقد الأدبي في العصر العباسي
تميّز العصر العباسي بازدهار الحركة الثقافية والفكرية، وكان من أبرز وجوه هذا الازدهار الناقد والمفكر قدامة بن جعفر، الذي اعتُبر رائداً في مجال التنظير النقدي العربي. أسهم بشكل فعّال في نقل النقد الأدبي من دائرة الانطباع الشخصي والذوق العام إلى ميدان التحليل العلمي والمنهجي، وذلك من خلال مؤلفاته التي ركّزت على تقنين المعايير وتحديد الضوابط النقدية. تميّز بنظرته العميقة للنصوص الشعرية والنثرية، وربط بين علمي البلاغة والمنطق، ما أتاح له إنتاج إطار نقدي متماسك ومبني على أسس علمية.

تفرّد قدامة بن جعفر بقدرته على الجمع بين ما هو لغوي وجمالي وما هو عقلي ومنطقي، فقد استخدم أدوات التحليل البلاغي، إلى جانب مفاهيم الفلسفة والمنطق، ليدرس النصوص الأدبية دراسة معمقة وشاملة. أدرك مبكراً أهمية بناء منهج نقدي منضبط، فعمل على تصنيف عناصر الشعر وتحديد مقاييس الجودة فيه، واعتبر أن النص الأدبي ليس فقط أداة للتعبير، بل بناء له قوانينه التي يجب فهمها وتحليلها. لذلك جاءت دراساته لتضع أسساً واضحة يمكن البناء عليها لتقويم النصوص.
اعتمد في كتابه “نقد الشعر” على تحليل البنية الشعرية من حيث المعنى واللفظ والوزن والأسلوب، فجاء نقده دقيقاً ومنهجياً، يخلو من العشوائية والانطباعات العابرة. لم يكتف بالوصف، بل سعى إلى تأصيل المفاهيم وتحديد القيم الجمالية في الشعر، ما جعله في طليعة من أسّسوا النقد الأدبي في الثقافة العربية. ومن خلال هذا الإسهام العميق، تمكن قدامة بن جعفر من وضع بصمته الفكرية والنقدية في مسار تطور النقد الأدبي العباسي، وجعل من النقد علماً مستقلاً ذا قواعد ومعايير.
نشأة قدامة بن جعفر وبداياته الفكرية
نشأ قدامة بن جعفر في بيئة علمية متعددة الروافد، فقد وُلد في منطقة يُرجّح أنها البصرة، ثم انتقل إلى بغداد التي كانت آنذاك مركزاً للعلوم والآداب في الدولة العباسية. أتاحت له هذه النشأة المبكرة أن يكون على تماس مباشر مع نخبة العلماء والأدباء، مما ساعده على اكتساب ثقافة واسعة منذ صغره. نشأته الدينية كانت نصرانية، ثم أعلن إسلامه في فترة لاحقة، ما يدل على مرونة فكره وانفتاحه على الأفكار المتعددة، وهذا ما انعكس لاحقاً في مسيرته النقدية.
بدأت اهتماماته الفكرية بالتبلور في سن مبكرة، حيث تفرّغ لدراسة اللغة العربية وعلوم البلاغة والمنطق والفلسفة، وبرزت لديه منذ ذلك الوقت ميول تحليلية واضحة. أبدى شغفاً خاصاً بالربط بين اللغة والمعاني العقلية، فراح يبحث عن أطر معرفية تتيح له فهماً أعمق للنصوص الأدبية. شكّلت هذه البدايات قاعدة فكرية صلبة مكّنته لاحقاً من تأسيس منهج نقدي متكامل. ولم تكن دراسته سطحية، بل كانت قائمة على تعمّق واستيعاب واسع لأصول العلم ومناهجه المختلفة.
تأثرت بداياته أيضاً بالتوجه العلمي العام في العصر العباسي، الذي أولى اهتماماً كبيراً بالمنطق والتحليل والبحث الفلسفي. تلقّى علومه على أيدي كبار العلماء، واطّلع على التراث النحوي والبلاغي الذي سبق عصره، فاستفاد منه في بناء رؤيته النقدية. هذه التراكمات المعرفية لم تأتِ صدفة، بل كانت نتيجة جهد متواصل وسعي دؤوب للفهم والتحليل، وهو ما جعل قدامة بن جعفر لاحقاً شخصية نقدية ذات طابع خاص يجمع بين التراث والتجديد.
البيئة الثقافية التي أسهمت في تكوين شخصيته النقدية
جاءت البيئة الثقافية في العصر العباسي مشجعة على الإنتاج الفكري والنقدي، وشكلت خلفية قوية ساهمت في تكوين شخصية قدامة بن جعفر. احتضنت بغداد، مركز العلم آنذاك، مختلف التيارات الفكرية، من فلسفة وعلوم شرعية وبلاغة، وكانت ملتقى العلماء والمفكرين. في هذه الأجواء المنفتحة والمتنوعة، وجد قدامة فضاءً رحباً لتطوير أفكاره، حيث أتاحت له المدارس العلمية والمنتديات الأدبية فرصة الاحتكاك بالتيارات المختلفة وصقل أدواته الفكرية.
شهدت هذه المرحلة اهتماماً متزايداً بتقعيد العلوم وتدوينها، فكان لابد من ظهور نقّاد يملكون قدرة على التحليل والتنظير، وقد برز قدامة ضمن هذا السياق باعتباره ممثلاً لهذا التيار الجديد. تأثر بجو النقاش والمناظرة الذي كان سائداً في الأوساط العلمية، فتعلّم كيف يُفكك النصوص ويعيد بنائها وفق رؤية نقدية واضحة. لم يكن بعيداً عن الحركة الترجمية النشطة آنذاك، فاطّلع على ما نُقل من الفلسفة اليونانية، واستفاد من مفاهيمها في بناء جهازه المفاهيمي.
ساهم هذا الانفتاح الفكري في جعله ناقداً ذا رؤية موسّعة، لا تكتفي بالنقل بل تسعى إلى التجديد والإبداع. أتاح له هذا المناخ العلمي أن يتجاوز مرحلة التلقي إلى مرحلة الإنتاج والتأليف، فبدأ يضع تصوّراته الخاصة حول النص الأدبي، وراح يطوّر مناهج التحليل، مستفيداً من الحوارات الفكرية الدائرة حوله. في ظل هذه البيئة الثرية، تشكّلت شخصيته النقدية المتوازنة، القادرة على الجمع بين أصالة التراث وضرورات المعاصرة.
أبرز المؤثرات الفكرية على منهجه في التحليل الأدبي
تأثر منهج قدامة بن جعفر النقدي بعدة عوامل فكرية تركت بصمتها في رؤيته التحليلية، فقد جاءت كتاباته نتيجة تفاعل بين عدد من المكونات الفكرية التي تشكّلت لديه عبر مراحل مختلفة. أول هذه المؤثرات تمثل في اطلاعه العميق على التراث البلاغي العربي، حيث درس علم البيان والبديع والمعاني، واستوعب ما أنتجه النقّاد السابقون من قواعد وأساليب، مما منحه قاعدة لغوية صلبة للتحليل.
كما ظهر تأثير الفلسفة والمنطق بشكل واضح في منهجه، فقد تبنّى أسلوب التصنيف والتقسيم عند تناوله للنصوص، وعالج الشعر بوصفه نظاماً يمكن تفكيكه وفهم أجزائه بشكل علمي. لم ينظر إلى الشعر كحالة وجدانية فحسب، بل كمنظومة لغوية تحمل بنية داخلية تتطلب التحليل والفهم. ومن هذا المنطلق، أدخل مصطلحات نقدية جديدة، واعتمد على المفاهيم العقلية في تقييم جودة الشعر وتماسك بنائه.
علاوة على ذلك، جاء تأثره بالتوجّه العقلي العام في الثقافة العباسية، حيث كانت العلوم تسير في اتجاه التقعيد والتنظير. هذه الروح المنهجية انسحبت على دراساته النقدية، فكان أكثر ميلاً إلى الصرامة المنطقية من الانطباعية الذوقية. وبهذا الدمج بين البلاغة والمنطق، استطاع قدامة بن جعفر أن يبتكر أسلوباً تحليلياً خاصاً، يعكس تمازج الفكر الجمالي بالفكر العقلي، وهو ما جعل من رؤيته النقدية واحدة من أكثر الرؤى تطوراً في تاريخ النقد العربي.
مفهوم النقد عند قدامة بن جعفر وأهم إضافاته النظرية
شهدت حركة النقد في العصر العباسي نقلة نوعية مع بروز شخصية قدامة بن جعفر، الذي عُدّ من أوائل من سعى إلى تأصيل النقد الأدبي العربي وفق قواعد عقلية ومنهجية. لم يُقدِم على النقد بوصفه انطباعًا ذاتيًّا أو ذوقًا فرديًا، بل سعى إلى تأطيره كعلم مستقلٍّ يستند إلى أسس واضحة. لذلك انطلق من تحديد ماهية الشعر بوصفه “قولًا موزونًا مقفّىً يدل على معنى”، وهي صياغة حاول من خلالها الإشارة إلى العناصر الجوهرية في بناء النص الشعري، مفرقًا بين الشكل والمضمون، ومؤسسًا لتصور شامل حول معايير الجودة والرداءة في العمل الأدبي.
اتخذ قدامة بن جعفر من التحليل العقلي أداة لفهم بنية الشعر ومقاصده، ففرّق بين العناصر الصوتية كالوزن والقافية، وبين العناصر الدلالية كالمعنى والصورة، وأخضعها جميعًا لمعايير صارمة. لم يُغفل دور التناسق بين هذه العناصر، بل اعتبره مقياسًا للفصاحة والبلاغة. كذلك رأى أن جودة الشعر لا تتحقق إلا بتضافر اللفظ والمعنى، ولذلك قام بتصنيف الأشعار بحسب درجة تحقق هذه الوحدة بين الشكل والمحتوى، مما كشف عن وعي نقدي متقدّم يفوق ما اعتاده النقاد السابقون.
ساهم قدامة بن جعفر في تطوير نظرية نقدية عربية متماسكة، تقوم على قواعد عقلية ومنطقية تستوعب تفاصيل العمل الأدبي ومكوناته. لم يتوقف عند وصف النصوص، بل سعى لتقنين آليات التقييم، وتوضيح مواطن الجمال والخلل في النص الشعري. ومن خلال هذا الجهد، أرسي دعائم التفكير المنهجي في النقد، ممهّدًا الطريق لنقلة نوعية في فهم وظيفة النقد الأدبي، مما يجعله أحد أبرز رواد التنظير النقدي في العصر العباسي.
تعريف النقد في فكر قدامة وموقعه من التراث العربي
ارتكز تصور قدامة بن جعفر للنقد على كونه عملية عقلية تهدف إلى التمييز بين الجيد والرديء في الشعر، بعيدًا عن الذوق المجرد أو الانطباع الشخصي. لم يكتفِ برصد الجوانب الشكلية في القصيدة، بل تجاوز ذلك إلى تقويم المعنى ومدى توافقه مع المبنى، وهو ما جعله ينظر إلى الشعر بوصفه صناعة لها قواعدها وحدودها. لذا عرّف الشعر بعبارة جامعة تُبرز أهم خصائصه، معتمدًا على فكرة التناسب بين الوزن والمعنى والقافية، مع ضرورة دلالة النص على غرض محدد.
لم يخرج تصور قدامة للنقد عن السياق العام للتراث العربي، بل حاول أن يطوّره ويعيد تنظيمه وفق قواعد علمية أكثر دقة. تأثر بالنقاد السابقين الذين أشاروا إلى عناصر الفصاحة والبلاغة، غير أنه تفرد بجعل تلك العناصر ضمن نسق منطقي يتيح تحليل النصوص وتصنيفها وفق درجات من الجودة. لذلك اعتُبر عمله امتدادًا للجهد النقدي الذي بدأه النقاد القدامى، لكنه أضاف إليه أبعادًا جديدة مكّنته من تجاوز النقد القائم على التذوق والذوق العام إلى رؤية أقرب إلى العلمية.
جعل قدامة من النقد أداة إجرائية يمكن استخدامها لتحليل أي نص شعري، دون الارتهان إلى المرجعية الشخصية أو المزاج الفردي، وهو ما ساهم في تعزيز مكانته داخل التراث العربي بوصفه واضع أول محاولة حقيقية لتنظيم النظرية النقدية. بذلك احتل موقعًا رياديًا، وترك أثرًا بالغًا في مسار النقد اللاحق، حيث استندت كثير من الأطروحات النقدية التي تلته إلى ما أسسه من مبادئ وأفكار، مما يبرهن على أصالة مشروعه واتساقه مع حركة تطور الفكر النقدي في الثقافة العربية.
الأسس العقلية والمنهجية في تنظيره النقدي
استند قدامة بن جعفر في تنظيره النقدي إلى منهجية عقلية متماسكة، مستوحاة من أدوات المنطق والفلسفة التي كانت شائعة في البيئة الثقافية العباسية. بدأ بتحديد المفاهيم وتفسير الأصول، فكان أول من وضع تعريفًا محددًا للشعر يراعي بنيته وخصائصه، وقد تناول النقد بوصفه علمًا له منطلقات وأدوات، لا يقتصر على الذائقة أو الانطباع. وقد اعتمد على آلية التصنيف، حيث قسّم الشعر إلى عناصره الأولية ثم درس مدى التناسق بينها لتحديد مدى جودته.
وظّف قدامة مفاهيم مستمدة من المنطق الأرسطي مثل الحد والتقسيم والجنس والفصل في تحليل النصوص الأدبية، فتعامل مع القصيدة وكأنها كيان منطقي قابل للتحليل والتفكيك. تميزت دراسته للعناصر الشعرية بأنها شاملة، فلم يقتصر على اللفظ أو الوزن، بل شمل المعنى، والغاية من الخطاب، والأثر الذي يتركه في المتلقي. لذلك جاء تحليله للنصوص بمستوى عالٍ من الدقة، وربط بين مكونات القصيدة وفق بنية منهجية واضحة تُمكن من قياس مواطن القوة والضعف بدقة.
مثّلت هذه الأسس نقطة تحول في تاريخ النقد العربي، إذ نقلته من مجرّد ملاحظات انطباعية إلى نسق علمي واضح المعالم. لم يكن غرضه فقط التقويم، بل سعى إلى إنشاء جهاز مفاهيمي متكامل يمكن الاستناد إليه في دراسة أي عمل أدبي. بهذه الرؤية، نجح قدامة بن جعفر في بلورة خطاب نقدي عقلاني ظلّ مرجعًا في القرون اللاحقة، وأصبح التنظير النقدي بعده أكثر اتساقًا بفضل ما أرساه من أدوات تحليل ومنهجية علمية دقيقة.
تأثير الفلسفة والمنطق في رؤيته للأدب والبلاغة
تأثرت رؤية قدامة بن جعفر للأدب والبلاغة بشكل مباشر بالمنطق والفلسفة، خصوصًا من خلال انفتاحه على الفكر الأرسطي الذي شكّل الخلفية المعرفية لكثير من تصوّراته النقدية. لم يكن يتعامل مع الشعر بوصفه مجرد تعبير عاطفي، بل اعتبره خطابًا عقلانيًا يمكن تحليله وفق آليات فلسفية ومنطقية. لذلك لجأ إلى مفاهيم مثل الجنس والفصل والحد في تفسير عناصر النص الشعري، وهي أدوات مأخوذة من المنهج الفلسفي، استخدمها لإعادة تنظيم مفاهيم البلاغة والنقد.
استمد قدامة بعض مبادئه من فلسفة الأخلاق، كما هو ظاهر في تحديده لموضوعات المديح في الشعر، إذ ربطه بالفضائل لا بالمظاهر الخارجية. فرأى أن الشاعر الجيد هو من يمدح الصفات المعنوية كالعدل والشجاعة لا الشكل الجسدي أو الانتماء القبلي، مما يعكس تأثره برؤية فلسفية ترى أن الجمال الحقيقي يكمن في القيم لا في المظهر. هذه الرؤية دفعت به إلى إعادة ترتيب موضوعات الشعر ووضعها ضمن سلّم معياري يرتبط بالعقل لا بالعاطفة وحدها.
انعكس هذا التأثير في تنظيمه لكتابه “نقد الشعر”، حيث اعتمد أسلوبًا منطقيًا في العرض، بدءًا من التعريف، مرورًا بالتصنيف، وانتهاءً بالتقويم. اتسمت لغته بالدقة والصرامة العلمية، وبرز فيها حرصه على الاستدلال والتحليل العقلي، ما منح عمله طابعًا فلسفيًا بارزًا. وبذلك أصبح قدامة بن جعفر نموذجًا للنّاقد الذي جمع بين ثقافة الأدب وتقنيات المنطق، ونجح في توظيف أدوات الفلسفة في صياغة خطاب نقدي قادر على تفكيك النصوص وتحليلها بموضوعية علمية.
ما الذي جعل قدامة بن جعفر يتفوق على معاصريه؟
تكوّنت شخصية قدامة بن جعفر الفكرية من مزيج مميز من الثقافة العربية العريقة والانفتاح على الفلسفة والمنطق، مما مكّنه من بناء رؤية نقدية تتجاوز ما كان سائداً في عصره. استوعب العلوم العقلية إلى جانب علوم اللغة والبلاغة، فتعمّق في المعارف المتنوّعة التي كان لها أثر واضح في أسلوبه النقدي. ساعده هذا التنوع في طرح أفكار جديدة لم تكن مألوفة عند غيره من النقاد العباسيين، فظهر توجهه العقلاني في تحليل النصوص وتقييمها بعيدًا عن النزعة الذوقية التي سيطرت على أغلب الأحكام النقدية في تلك المرحلة.

برع قدامة في الجمع بين الجانب التنظيري والتطبيقي، فقدّم في كتبه النقدية منهجًا متماسكًا يقوم على تحديد عناصر النص الشعري وربطها بمعايير دقيقة. تميّز أسلوبه بالوضوح والتنظيم، فعرّف الشعر ضمن قالب محدد، وركّز على العلاقة بين الشكل والمضمون، كما وضع مفاهيم مثل الجودة والرداءة في الشعر بناء على تحليل عناصره وليس على الانطباع الشخصي. بهذه الطريقة أسهم في الانتقال بالنقد الأدبي من دائرة الذوق الفردي إلى إطار أقرب إلى العلم، وجعل من الممارسة النقدية أداة لتحليل النصوص وفق معايير ثابتة.
ساهمت البيئة الثقافية التي عاش فيها قدامة في تنمية قدراته، إذ وُلد في بغداد خلال فترة زاخرة بالحركة الفكرية، مما أتاح له الاطلاع على ترجمات الفلسفة والمنطق والعلوم اليونانية التي أثّرت بشكل ملحوظ في منهجه النقدي. استثمر هذا التفاعل بين الثقافة الإسلامية والوافدة ليطوّر مفاهيم نقدية جديدة، فابتعد عن الأحكام الجاهزة، واعتمد بدلاً منها على التحليل الموضوعي للنص. ولهذا السبب تميز عن معاصريه واعتُبر حجر الأساس في بناء النظرية النقدية في العصر العباسي.
المقارنة بينه وبين النقاد في العصر العباسي
اختلفت النظرة النقدية بين قدامة بن جعفر والنقاد الآخرين في العصر العباسي من حيث المنهج والغاية، فقد وُجد من النقاد من اهتم بالسرد التاريخي لتصنيفات الشعراء دون الخوض في تحليل العناصر الفنية للنصوص. بينما حاول البعض تقديم ملاحظات نقدية انطباعية، إلا أنهم لم يتبنوا إطارًا منهجيًا متكاملًا يمكن من خلاله تقويم الشعر بشكل علمي. اعتمد معظم هؤلاء النقاد على الذوق الأدبي والخبرة الشخصية، ما جعل أحكامهم تتفاوت تبعًا لتجاربهم وانطباعاتهم.
برز تميّز قدامة من خلال ابتعاده عن الأساليب التقليدية وتبنّيه منهجًا نقديًا ذا طابع فلسفي ومنطقي. جعل من الشعر موضوعًا للدراسة والتحليل، لا مجرد مجال للتذوق الجمالي. لم يكتف بتحديد صفات الشعر الجيد، بل فسّر أسباب الجودة والرداءة في النصوص، مستعينًا بمفاهيم مستمدة من المنطق والفلسفة. بينما تمسّك النقاد الآخرون بالمفردات البلاغية كأدوات وحيدة للنقد، وسع قدامة أدواته لتشمل الجوانب الفكرية والبنائية للنص، فقدم بذلك قراءة أكثر شمولية.
ساهم الفرق بينه وبين النقاد الآخرين في ترسيخ مكانته باعتباره ناقدًا منهجيًا، لا مجرد صاحب رأي. بينما كان النقاد الآخرون ينظرون إلى النص الأدبي ككيان مستقل يمكن الحكم عليه فورًا، آمن قدامة بضرورة تحليل مكوناته الداخلية وربطها ببعضها. من خلال هذا التصور، نقل النقد من التقييم العاطفي إلى الدراسة العلمية، وبذلك أصبح نموذجًا مختلفًا داخل المشهد النقدي العباسي، مما جعله يتفوق عليهم في الطرح والمحتوى والمنهج معًا.
منهجه في الربط بين الشكل والمضمون في النص الأدبي
نظر قدامة بن جعفر إلى النص الأدبي بوصفه كيانًا متكاملاً، لا يمكن تجزئته أو الفصل بين عناصره. بنى منهجه النقدي على الاعتقاد بأن الشكل والمضمون عنصران مترابطان، ولا يمكن أن يتحقق التأثير الأدبي الكامل من دون انسجامهما. لم يكتف بتقييم النص من حيث فصاحة الألفاظ أو جزالة المعاني، بل اهتم بكيفية تفاعل اللفظ مع المعنى، والوزن مع القافية، ومدى تعاضد هذه المكونات لإنتاج نص ناجح من الناحية الفنية.
أسهم هذا التصور في تطوير فكرة جديدة للنقد تقوم على الربط العضوي بين البنية الشكلية والمحتوى الدلالي. اعتبر قدامة أن كل خلل في أحد عناصر الشكل قد يؤثر سلبًا على المعنى، والعكس صحيح. لهذا رأى أن جودة النص لا تقاس بجمال اللفظ أو عمق المعنى فقط، بل بمدى تفاعل هذه العناصر معًا داخل سياق متكامل. دعم هذه الرؤية بتحليل مفصل للأنماط الشعرية، وبيّن كيف يمكن أن يؤدي التوافق بين الشكل والمضمون إلى إعلاء القيمة الفنية للنص.
قدّم قدامة نموذجًا نقديًا متوازنًا يبتعد عن الإفراط في التركيز على الشكل كما يفعل بعض النقاد، أو الاهتمام بالمضمون وحده كما كان شائعًا عند البعض الآخر. أوجد مسافة وسطى تجمع الجمال الظاهري للنص بعمقه الداخلي، مما جعل منهجه أكثر مرونة وقابلية للتطبيق على أنواع متعددة من النصوص. هكذا لم يكن رائدًا في التنظير النقدي فحسب، بل كان مجددًا في فهم العلاقة الجوهرية بين الشكل والمضمون في الأدب العربي.
نظرته للبلاغة بوصفها أداة للتقويم الجمالي
فهم قدامة بن جعفر البلاغة بوصفها جزءًا لا يتجزأ من العملية النقدية، وليست مجرد وسيلة للزينة اللفظية. رأى في البلاغة أداة لتحسين المعنى وتوضيح الفكرة وتجميل الأسلوب بما يخدم الغرض الأدبي للنص. لم يتعامل معها كألعاب لفظية أو تراكيب زخرفية، بل اعتبرها معيارًا يمكن من خلاله قياس جودة النص الشعري والنثري. ولذلك ارتبطت عنده البلاغة ارتباطًا مباشرًا بالتقويم الجمالي للنصوص، وأصبحت وسيلته المفضلة للحكم على الإبداع الأدبي.
انطلق قدامة من فكرة أن البلاغة الحقيقية تتجلّى حين تتسق مع المعنى وتؤدي إلى تعميق الأثر الفني، لا حين تنفصل عنه. وعليه فقد نظر إلى المحسنات البلاغية بوصفها عناصر يجب أن تنسجم مع مضمون النص، لا أن تكون زائدة عن الحاجة. حدّد بذلك الفرق بين البلاغة النافعة والبلاغة المتكلّفة، حيث لا يقبل أن يكون التجويد اللغوي غاية في ذاته، بل يجب أن يكون وسيلة لإيصال الفكرة بشكل أكثر دقة وجمالاً.
عكست هذه النظرة مدى وعي قدامة بأهمية البلاغة في تطوير النص الأدبي، لكنه لم ينسحب إلى التعميم أو المغالاة. بل حافظ على توازن دقيق بين المعايير البلاغية والمعايير النقدية الأخرى، ما جعله يقدّم قراءة أدبية دقيقة وشاملة. بذلك أسهم في ترسيخ البلاغة كأداة للتقويم الفني، لا مجرد تقنية تزيينية، وهو ما منح مشروعه النقدي أبعادًا جديدة تجاوزت ما كان مطروحًا في عصره، ورسّخت اسمه كأحد أبرز المنظرين للنقد الجمالي في الأدب العربي.
أهم مؤلفات قدامة بن جعفر في التنظير النقدي
تميّزت مؤلفات قدامة بن جعفر بتنوعها وتكاملها من حيث الوظيفة النقدية، إذ لم يكتفِ بتقديم ملاحظات ذوقية أو تعليقات بلاغية تقليدية، بل سعى لتأسيس منظومة فكرية متماسكة يمكن من خلالها تقييم النصوص الأدبية. شكّلت هذه المؤلفات منعطفاً في تاريخ النقد العربي، لأنها تجاوزت مرحلة الانطباع إلى مرحلة التأصيل والتقعيد. لم يكن اشتغال قدامة منصباً على الشعر فحسب، بل امتد إلى قضايا اللغة والكتابة والتأليف، ما يعكس نظرته الواسعة إلى العملية الأدبية.
جاء كتاب “نقد الشعر” في طليعة مؤلفاته النقدية وأكثرها شهرة، فقد وضع فيه تعريفاً للشعر وحدد عناصره الأساسية من وزن وقافية ومعنى، كما ناقش العلاقة بين هذه العناصر بطريقة منطقية تؤكد تأثره بالثقافة الفلسفية التي كانت شائعة في عصره. بجانب ذلك، ألف كتاب “جواهر الألفاظ” الذي يعكس اهتمامه بجمالية اللغة من حيث المفردات ودلالاتها، إذ عمل فيه على ترتيب الألفاظ وتصنيفها ضمن سياقات بلاغية معينة، مما يدل على أن رؤيته للنقد تجاوزت المعنى إلى بنية التعبير.
أضاف إلى ذلك كتاب “الخراج وصناعة الكتابة” الذي توسّع فيه في الحديث عن الكتابة من منظور إداري وأدبي معاً، مما يُظهر اهتمامه بتقنيات التعبير وأساليبه في الكتابات الرسمية. كما كتب في موضوعات أخرى مثل “السياسة” و”الرد على ابن المعتز”، وجميعها تكشف عن انخراطه في السجال الثقافي والنقدي السائد في العصر العباسي. بهذه المؤلفات، أسهم قدامة بن جعفر في ترسيخ مفاهيم نقدية ساهمت في صياغة وعي أدبي مختلف، يقوم على التحليل والعقلنة بدلًا من الإعجاب أو الاستحسان العابر.
كتاب “نقد الشعر” وأثره في تطور النقد العربي
يُعد كتاب “نقد الشعر” لقدامة بن جعفر من أبرز ما كُتب في بداية التأسيس النظري للنقد الأدبي عند العرب، فقد شكّل نقلة نوعية في دراسة الشعر العربي عبر منهج عقلاني واضح. لم يكتفِ قدامة بإبداء الرأي في جماليات الشعر، بل سعى لتحديد معايير دقيقة يمكن من خلالها تقييم جودة القصيدة. بدأ ذلك بتعريفه الشهير للشعر باعتباره قولًا موزونًا مقفى يدل على معنى، وهو تعريف جمع بين الشكل والمضمون في وحدة واحدة.
اعتمد في هذا الكتاب على أسلوب تصنيفي شمل أنواعًا متعددة من المعارف المرتبطة بالشعر، مثل علم العروض والقافية واللغة والمعاني، إضافة إلى محور خاص بجودة الشعر ورداءته. أظهر هذا التنظيم النزعة المنهجية لدى قدامة، وساهم في جعل الشعر موضوعًا قابلاً للدراسة وفق قواعد محددة، لا مجرد تذوق ذاتي أو مزاج فردي. كما ناقش العلاقة بين اللفظ والمعنى، وبين البناء الشعري والإحساس الجمالي، مما جعله يتفرد عن سابقيه في التناول النقدي.
أثّر الكتاب لاحقًا في تطور النقد الأدبي العربي من خلال تقديمه لنموذج قابل للتعميم، بحيث يمكن استخدامه في نقد شعر مختلف العصور. كما ألهم عددًا من النقاد اللاحقين الذين ساروا على نهجه في تحليل النصوص الشعرية، واستفادوا من طريقته في الربط بين الشكل والمحتوى. بذلك، أسس قدامة بن جعفر لمرحلة جديدة في تاريخ النقد، نقلت الشعر من كونه فنًا محكومًا بالذوق إلى مجال معرفي يتطلب أدوات تحليلية دقيقة.
مؤلفات أخرى أسهمت في صياغة الوعي النقدي العباسي
لم يقتصر دور قدامة بن جعفر النقدي على كتابه “نقد الشعر”، بل أنتج عددًا من المؤلفات التي كان لها دور فعّال في تطور الوعي النقدي خلال العصر العباسي. حملت هذه الكتب طابعًا تنظيريًا يظهر حرصه على تأسيس أطر فكرية ومعرفية يمكن الرجوع إليها في تقييم النصوص ومقاربتها. مثلت هذه المؤلفات امتدادًا لمشروعه النقدي الهادف إلى عقلنة الخطاب الأدبي وربطه بعلوم اللغة والفكر والمنطق.
يأتي في مقدمة هذه الكتب كتاب “جواهر الألفاظ” الذي عالج فيه مسألة المفردة من زاوية بلاغية دقيقة، إذ ركّز على العلاقة بين اللفظ والمعنى وعلى كيفية استخدام الكلمات بشكل فعّال في الخطاب الأدبي. لم يتوقف عند جماليات اللغة، بل تناول تنظيمها ضمن حقول دلالية تجعل النص أكثر انسجامًا ودقة، الأمر الذي يكشف عن حسه النقدي المتطور. أما كتاب “الخراج وصناعة الكتابة”، فقد دمج فيه بين الوظيفة الإدارية للكتابة وجماليات التعبير، مما أتاح له توسيع دائرة النقد لتشمل أنواعًا متعددة من النصوص.
كما أضاف كتاب “الرد على ابن المعتز” بعدًا جدليًا لمشروعه النقدي، إذ خاض فيه نقاشًا مع الاتجاهات البلاغية التقليدية، خاصة تلك التي قدّمها ابن المعتز في تفضيله للشاعرية التزينية على حساب المعنى. كشف هذا الكتاب عن قدرة قدامة على الدخول في نقاشات فكرية عميقة، وعلى توظيف أدواته المنهجية في الدفاع عن آرائه. من خلال هذه المؤلفات المتنوعة، أسهم قدامة بن جعفر في إثراء النقاش النقدي وإرساء أسس جديدة لتحليل النصوص.
الخصائص الأسلوبية والفكرية في كتبه النقدية
تميّزت كتابات قدامة بن جعفر النقدية بسمات فكرية دقيقة وأسلوبية متمايزة، جعلت منها نموذجًا في التنظير النقدي العباسي. امتلك قدرة على الجمع بين الدقة العلمية والأسلوب الأدبي الجاذب، ما منح نصوصه طابعًا فريدًا. ارتكز في تحليله للنصوص على منهج عقلي قائم على التصنيف والتفكيك، فتعامل مع القصيدة كوحدة متكاملة يجب تحليل أجزائها لفهم كليتها، لا كمنتج عاطفي منفصل عن المعايير.
كما ظهر تأثره الواضح بالفكر الفلسفي والمنطقي الذي كان رائجًا في بيئته، خصوصًا في توظيفه للمفاهيم التحليلية التي تُمكّن الناقد من الوصول إلى تقييم علمي للنص. لم يكتفِ بتوصيف جماليات النصوص، بل حاول تفكيك بنيتها وتوضيح العلاقات بين مكوناتها، وهو ما جعل نقده أقرب إلى العلم منه إلى الانطباع. هذا التأثر منح كتاباته عمقًا إضافيًا، وأظهر اهتمامه بالبحث عن معايير موضوعية لفهم الشعر.
إلى جانب ذلك، اهتم في كتبه بالجوانب البلاغية واللغوية التي تعكس مهارة الكاتب وقدرته على صياغة الجمل المؤثرة، فربط بين البلاغة والنقد في إطار واحد. لم يعزل المعنى عن الشكل، بل تعامل معهما كعنصرين متكاملين، مما أتاح له تقديم رؤية نقدية متماسكة. بذلك، جسّدت مؤلفاته نقدًا متقدمًا استطاع الجمع بين جماليات اللغة ودقة الفكر، وجعل من قدامة بن جعفر رمزًا لمرحلة انتقالية حاسمة في تاريخ النقد العربي.
التحليل الأسلوبي واللغوي في فكر قدامة بن جعفر
يُظهر فكر قدامة بن جعفر وعياً نقدياً مبكراً بمفهوم الأسلوب واللغة بوصفهما عنصرين حيويين في بنية النص الشعري، حيث لم يتوقف عند حدود الشكل الخارجي أو الجمالية السطحية، بل تجاوز ذلك إلى تحليل بنية النص داخلياً. فقد انطلق من فكرة أن الشعر صناعة لها مكوّنات محددة تتآلف فيما بينها، وتشمل الوزن، القافية، اللفظ، والمعنى، وبالتالي فإن أي خلل في توازن هذه المكوّنات ينعكس سلباً على جودة النص. وبذلك، رسّخ تصوّراً نقدياً يقوم على فهم الشعر كمنتج لغوي له آليات منظمة، وليس تعبيراً عشوائياً عن المشاعر.
استند قدامة في تحليله إلى منطق لغوي صارم، حيث فسّر التراكيب والأساليب على ضوء قواعد معرفية مستمدة من علم الكلام والمنطق، ما يعكس انفتاحه على الثقافة العقلية التي سادت في العصر العباسي. وقد حاول من خلال هذا التحليل أن يجعل من الأسلوب بُعداً دلالياً يتجاوز الزخرفة اللفظية ليصير أداة فاعلة في إيصال المعنى وإبراز جماليات النص. ومن خلال التركيز على العلاقة العضوية بين اللفظ والمعنى، أرسى منهجاً نقدياً يربط بين التراكيب اللغوية والرسائل المضمونية، في مسعى إلى تقويم النصوص بشكل شمولي ومتوازن.
يتجلى اهتمام قدامة بالأسلوب في سعيه لتقنين اللغة الشعرية وإخضاعها لقواعد، حيث رأى أن التماسك الأسلوبي شرط أساسي لجودة العمل الأدبي، لأن اللغة لا تعمل بوصفها وسيلة توصيل فقط، بل تمثّل البنية الأساسية التي يحمل المعنى نفسه من خلالها. ومن هنا، يُفهم أن رؤيته لم تكن مجرّد تنظير بلاغي، بل محاولة منهجية لربط الجانب الفني بالجانب العقلي، في إطار مشروع نقدي متكامل يهدف إلى تحويل الشعر من تجربة ذاتية إلى نص يمكن تحليله ومعالجته بمفاهيم علمية. وفي ضوء هذا التصور، تبرز مكانة قدامة بن جعفر بوصفه رائداً في التنظير النقدي خلال العصر العباسي.
نظرية الوزن والمعنى في تقويم الشعر
ينطلق قدامة بن جعفر في رؤيته لتقويم الشعر من مفهوم مزدوج يجمع بين الوزن والمعنى، باعتبارهما جوهر العملية الشعرية، حيث لا يُمكن لأي منهما أن ينفصل عن الآخر دون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بقيمة النص. ومن هذا المنظور، أكّد على أن الشعر الجيد لا يُقوَّم من خلال الوزن وحده، ولا من خلال المعنى فقط، بل من خلال مدى تلاحم الاثنين واتساقهما معاً. وقد اعتبر أن الوزن حين يُستخدم بشكل يخدم المعنى ويُبرز دلالاته، يصبح أداة فعالة في نقل الشعور والإبداع، أما إذا أصبح عبئاً على المعنى، فإنه يفقد وظيفته الجمالية.
سعى قدامة إلى تصنيف الشعر بحسب درجات الاتساق بين الوزن والمعنى، إذ رأى أن التوازن بين الجانبين لا يُعزز فقط جمالية النص، بل يضمن أيضًا تماسكه البنائي. وضمن هذا السياق، قسّم أنماط العلاقات الممكنة بين عناصر الشعر المختلفة، فحدد علاقات الائتلاف والافتراق، وبيّن أن أعلاها هو تضافر اللفظ والمعنى والوزن في وحدة متكاملة. وبالتالي، اعتبر أن قيمة القصيدة تتأتى من قدرتها على الجمع بين جزالة اللفظ، سلاسة الوزن، وعمق المعنى في قالب واحد لا ينفصل بعضه عن بعض، مما يمنح العمل الشعري نوعاً من الاكتمال الفني.
تعكس هذه النظرية وعياً نقدياً متقدماً بطبيعة النص الشعري، إذ لم يركّز على الجانب الموسيقي فحسب، بل مزج بين الإيقاع والدلالة، وجعل من المعنى مقياساً أساسياً للحكم على جودة الوزن نفسه. وقد أتاح هذا الدمج بين البُعدين النظري والعملي إطاراً نقدياً يسمح بتقويم الشعر وفق معايير موضوعية واضحة، ترتكز على التكامل بين الشكل والمضمون. وبذلك، مهّد قدامة بن جعفر الطريق لمدرسة نقدية ترى أن الشعر لا يُقاس فقط بما يُطرب الأذن، بل بما يُغني الفكر أيضاً، فيجمع بين المتعة والعمق في آن واحد.
مفهوم الإعجاز البلاغي في أعماله النقدية
عالج قدامة بن جعفر مسألة البلاغة من زاوية نقدية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة الإعجاز، دون أن يصوغها بالمصطلح المتداول لاحقاً، لكنه أرسى أسس هذا المفهوم من خلال تفكيكه لخصائص الأسلوب الشعري الجيد. فقد ركّز على كيفية اندماج المعنى مع الأسلوب في صورة تُحدث أثراً جمالياً ومعرفياً في آن واحد، وهو ما يمكن وصفه بإعجاز بلاغي ضمني. انطلقت رؤيته من أن البلاغة لا تقتصر على الجمال اللفظي، بل تشمل عمق الدلالة وتناسب الصورة البيانية مع الغرض الشعري.
بيّن قدامة أن النص الشعري المُتقَن هو الذي يُراعي النسب بين أجزائه، ويتجنب الزوائد اللفظية والتراكيب المعقدة التي تشتت المعنى. ومن خلال تحليله لأمثلة من الشعر، أشار إلى ظواهر بلاغية مثل التكرار والغرابة والطباق، موضحاً متى تصبح هذه العناصر عنصراً بلاغياً يُثري النص، ومتى تتحول إلى عيب يُضعف البناء. بذلك، عالج البلاغة بوصفها علماً يمكن فحصه وفق ضوابط ومعايير، وليس مجرد انطباع ذاتي. وهذا المنظور جعله يقترب كثيراً من المفاهيم البلاغية الحديثة التي ترى في البلاغة أداة تحليلية قادرة على الكشف عن أسرار النص.
ترتكز مساهمته في هذا المجال على الجمع بين الذوق الجمالي والتحليل المنطقي، حيث اعتبر أن النص الذي يحقق الإعجاز البلاغي هو النص الذي يُراعي توازن الألفاظ، دقة الصور، وانسجام السياق. ومن هذا المنطلق، تتضح أهمية فكر قدامة بن جعفر في تشكيل وعي نقدي جديد يعتمد على أدوات تحليلية قادرة على تمييز الجمال الأدبي لا بوصفه معطى حسياً فقط، بل كتركيب معرفي وفني يستحق الدراسة. وهكذا تكتمل رؤيته النقدية التي تجمع بين المنهجية العقلية والتقدير الجمالي في آن واحد.
رؤيته للغة بوصفها أداة للإبداع لا مجرد وسيلة للتعبير
تُجسّد نظرة قدامة بن جعفر للغة تحوّلاً في فهم الدور الذي تؤديه داخل العمل الشعري، فقد تعامل معها بوصفها أداة منتجة للمعنى وليست مجرد وسيط ناقل له. وبذلك تجاوز التصورات التقليدية التي كانت ترى اللغة مجرّد وعاء يُصبّ فيه المعنى، ليُبيّن كيف أن طبيعة الألفاظ وتراكيبها تسهم في خلق الإبداع وليس فقط نقله. فقد رأى أن الشعر لا يُصاغ من المعاني أولاً ثم تُلبس له الألفاظ، بل تُبنى المعاني عبر الألفاظ في تداخل مستمر يصعب الفصل فيه بين الشكل والمضمون.
استثمر قدامة هذا التصور ليؤسس لقراءة نقدية جديدة ترى أن نجاح النص الشعري يتوقف على وعي الشاعر بقدرته على التحكم في اللغة بوصفها أداة تشكيل، لا بوصفها وسيلة للزينة أو الزخرفة. واعتبر أن الشاعر الذي يتقن السيطرة على أدواته اللغوية يستطيع أن يصوغ عالماً شعرياً متكاملاً، تتفاعل فيه الكلمة مع الصورة، والموسيقى مع الإيقاع، لتنتج أثراً فنياً متماسكاً. وهذا ما جعله يُعيد الاعتبار للمستوى اللفظي في النص دون أن يلغيه لصالح المعنى، بل أقام بينهما علاقة جدلية تعكس عمق الوعي اللغوي النقدي لديه.
أبرزت هذه الرؤية تقدماً في فهم اللغة داخل حقل النقد، حيث أعاد قدامة تشكيل التصورات التقليدية حول العلاقة بين اللفظ والمعنى، وفتح المجال أمام فهم أوسع للغة كأداة فنية تُسهم في إنتاج الدلالة وليس فقط توصيلها. وبذلك قدّم إسهاماً نوعياً في تطوير أدوات النقد العربي، حيث جعل اللغة محلاً للتحليل والنقد وليس فقط وسيلة لإجراء هذا النقد. ومن خلال هذا الإطار، يمكن فهم كيف أن قدامة بن جعفر استطاع أن يُعيد تعريف العملية الشعرية بأكملها، بدءاً من المفردة وانتهاء بالبنية الكلية للنص.
كيف ساهم قدامة بن جعفر في تأسيس علم الجمال الأدبي؟
شكّل قدامة بن جعفر نقطة تحوّل في مسيرة النقد الأدبي العربي حين انتقل به من مستوى الذوق العفوي إلى مقاربة منهجية تقوم على قواعد ومعايير محددة. اعتمد في ذلك على خلفيته الفلسفية والمنطقية، فقام بإدخال أدوات التحليل العقلي إلى ميدان البلاغة والشعر. لم يكتف بتوصيف النصوص الشعرية وفق الانطباعات، بل سعى إلى تصنيف عناصر الجمال وتصويرها ضمن إطار متماسك يجمع بين اللفظ والمعنى والإيقاع. ومن خلال تعريفه الشهير للشعر بأنه “قول موزون مقفى يدل على معنى”، بيّن أن الجمال الأدبي لا ينفصل عن القيمة الفكرية، بل يتكامل معها ليكوّن وحدة جمالية قائمة على الانسجام بين الشكل والمضمون.

ساهم قدامة بن جعفر في إرساء ملامح أولى لنظرية الجمال الأدبي من خلال تناوله الدقيق لعناصر النص الشعري، حيث رأى أن جودة الشعر تتحدد بمدى التوافق بين المعنى واللفظ، وبين الصورة والهدف، وبين الوزن والموسيقى الداخلية للنص. أدخل مفاهيم جديدة إلى الخطاب النقدي، مثل “اللفظ الخادم للمعنى” و”الشكل الحاوي للفكرة”، مؤسساً بذلك قاعدة عقلانية للجمال. ركّز على أهمية أن يخدم كل عنصر أدبي رسالة النص، فرفض الزينة الشكلية التي لا تضيف إلى المعنى، وفضّل البساطة المعبّرة على التعقيد الفارغ. وبذلك، تمكّن من الانتقال بالجمال من كونه إحساساً إلى كونه معياراً قابلاً للتحليل والمقارنة.
بفضل هذا الاتجاه، ساعد قدامة بن جعفر في فتح الطريق أمام أن يُنظر إلى الجمال الأدبي بوصفه مجالاً للتأمل العقلي والتحليل، لا فقط للاستمتاع الحسي أو الاستجابة الانفعالية. وقد أدّى هذا التحوّل إلى بناء تصور جديد للنقد يربط بين البلاغة والمنطق، ويعتبر أن الإبداع لا يتحقق إلا حين يلتقي الجمال بالشكل السليم، والفكرة بالصياغة المناسبة. وبهذا، أسّس قدامة أرضية صلبة لعلم الجمال الأدبي، حيث جعل من التناسق بين عناصر النص مقياساً رئيساً لجودته، ومن الانسجام بين اللفظ والمعنى شرطاً أساسياً لبلوغه مرتبة الفن الرفيع.
النظرة الفلسفية للجمال في التراث العباسي
برز في التراث العباسي اهتمام متزايد بمفهوم الجمال، تجاوز حدود التذوق والانفعال إلى آفاق التأمل الفلسفي والمعرفي. لم يكن الجمال يُنظر إليه كخاصية حسية فحسب، بل كقيمة فكرية لها أبعاد عقلية وروحية. استُمدت هذه الرؤية من تداخل الفكر الإسلامي مع الفلسفة اليونانية، خاصة من خلال أعمال المترجمين الذين نقلوا نصوص أرسطو وأفلاطون إلى العربية. وقد تأثرت المفاهيم الأدبية بهذا التوجّه، فظهر نقّاد ومفكرون يرون أن الجمال ليس وليد الإحساس فحسب، بل حصيلة تناسق عقلي بين أجزاء الشيء، وهو ما انعكس على نظرتهم للنصوص الأدبية.
اتجه النقاد العباسيون إلى اعتبار الجمال نتاجاً لعلاقة منطقية بين العناصر، حيث لا يُعد النص جميلاً إلا إذا اجتمعت فيه صفات متكاملة تخلق تناغماً بين الشكل والمحتوى. نشأ عن ذلك اهتمام بتحليل بنية النص لاكتشاف مدى توافق اللفظ مع المعنى، وتناسق الإيقاع مع الدلالة، وانسجام الفكرة مع الصورة البلاغية. ظهرت مفاهيم مثل “التناسب”، و”الانسجام الداخلي”، و”التوازن بين العقل والعاطفة”، وكلها تعبير عن فهم فلسفي للجمال ينبثق من ترتيب النص في بنيته الكلية، لا من مفرداته المنفصلة.
عبر هذه النظرة، تحول الجمال من كونه مظهراً حسياً إلى قيمة عقلية يمكن دراستها ومقارنتها. لم يعد الجمال في النص الأدبي قائماً على الزخرفة أو الصياغة الخارجية فقط، بل أصبح يتعلّق بمدى قدرته على التعبير عن المعنى بوضوح وعمق، ومدى انسجام هذا التعبير مع القواعد العقلية للنظم والبلاغة. وبذلك، أسس النقد في العصر العباسي لرؤية جمالية تتجاوز الحُكم الذوقي العابر، وتؤسس لفهم قائم على المنطق والمعيار، وهو ما مهد الطريق لأفكار قدامة بن جعفر وغيره من النقاد الذين جمعوا بين الفلسفة والبلاغة في مقارباتهم الجمالية.
الربط بين الجمال والمعنى في نقده الأدبي
اعتبر قدامة بن جعفر أن الجمال في النص الأدبي لا يُمكن فصله عن المعنى، بل رأى أن المعنى هو العنصر الجوهري الذي تُبنى عليه بقية العناصر الجمالية. انطلق من رؤية تؤمن بأن الشكل الأدبي، مهما بلغ من البراعة، لا يكتسب قيمته إلا حين يعكس معنى واضحاً أو فكرة ذات عمق. هذه المقاربة جعلت من المعنى أساساً للتقييم، حيث لا تُقدّر البلاغة أو الإيقاع أو الصور المجازية إلا بمدى خدمتها للمضمون الذي يقدّمه النص.
سعى إلى تحليل العلاقة بين اللفظ والمعنى بوصفها علاقة تفاعلية، يكون فيها اللفظ وسيلة لإظهار المعنى لا غاية في ذاته. رفض المبالغة في الزخرفة اللغوية إن لم تكن منسجمة مع الدلالة، واعتبر أن الألفاظ يجب أن تكون خادمة للمعاني، لا مُجرد حُلي لغوية. أدّى هذا التصور إلى منح المعنى أهمية قصوى، بحيث يُقاس الجمال الأدبي بمدى نجاحه في توصيل فكرة أو تجربة شعورية بوسائل لغوية منضبطة ومعبّرة. وبالتالي، تم تحديد المعايير الجمالية وفق مدى التوازن بين التعبير والمحتوى.
عبر هذه الرؤية، أرسى قدامة مفهوماً جديداً للنقد يُعلي من شأن الوظيفة الفكرية للنص، ويربطها بالجمال الأدبي كقيمة نابعة من تكامل الشكل والمضمون. لم يَعد يكفي أن يكون النص موزوناً أو مصوغاً بلغة شاعرية، بل ينبغي أن يعكس انسجاماً داخلياً بين عناصره، يُمكّنه من إيصال المعنى بطريقة راقية. وهكذا، ساهم في تطوير مفهوم الجمال ليشمل العمق الفكري إلى جانب الجمال الظاهري، مما أضفى على النقد الأدبي بُعداً تحليلياً جديداً يُميز بين النصوص وفق معايير موضوعية ومدروسة.
أثره في وضع معايير الذوق الأدبي عند النقاد اللاحقين
امتد تأثير قدامة بن جعفر إلى النقاد اللاحقين الذين اقتبسوا من منهجه الكثير من التصورات النقدية والمعايير الجمالية. ساعد في نقل الذوق الأدبي من كونه استجابة شعورية فردية إلى كونه إطاراً موضوعياً له ضوابط ومقاييس. كان لنظرته التي تمزج بين التحليل المنطقي والبلاغة العربية دور في إرساء تقاليد نقدية جديدة، حيث بدأ النقاد في استخدام مفاهيم أكثر تحديداً عند الحديث عن جودة النصوص الأدبية.
استند النقاد بعده إلى تصنيفه للعناصر الأدبية بوصفها مكونات مترابطة، فرأوا أن على النص الجيد أن يحقق التوازن بين اللفظ والمعنى، وأن يلتزم بالموسيقى الشعرية دون أن يفقد رسالته. نشأ عن ذلك نظام نقدي أكثر علمية، يسعى إلى تقييم النصوص وفق معايير محددة، لا مجرد الانطباع. وبهذا، شكّل تأثيره أساساً لما أصبح يُعرف لاحقاً بمقاييس الذوق الأدبي، والتي لم تعد تقوم على الذائقة الفردية، بل على أسس تحليلية يمكن تعميمها.
أدى هذا التحول إلى نشوء خطاب نقدي منظم، يتعامل مع الأدب كموضوع قابل للفحص والتفكيك، لا فقط كمجال للمتعة والتذوق. ومع مرور الزمن، أصبحت أفكار قدامة جزءاً من مرجعيات النقد العربي الكلاسيكي، تُستحضر عند محاولة وضع أحكام نقدية موضوعية. وهكذا، ساعد في إرساء تقاليد نقدية تجعل من الذوق الأدبي مجالاً معرفياً يمكن تدريسه وتطويره، لا مجرد تفاعل ذاتي، فساهم في بناء وعي نقدي يمتد تأثيره إلى مدارس النقد العربية حتى اليوم.
أثر قدامة بن جعفر في النقد العربي اللاحق
ساهم قدامة بن جعفر في إرساء منهج نقدي متكامل خلال العصر العباسي، وتمكّن من تحويل النقد الأدبي من اجتهادات ذوقية فردية إلى علم له أصول وضوابط. بدأ مشروعه النقدي من خلال تعريف الشعر بأنه قول موزون مقفّى يدل على معنى، وهو تعريف جمع فيه بين الشكل والمضمون، ما مهّد الطريق لفهم أكثر دقة لطبيعة النص الشعري. اتجه في مقاربته النقدية إلى تحليل عناصر النص الأدبي بطريقة منهجية، معتمدًا على تصنيف واضح للعناصر التي تكوّن الشعر، كاللفظ والمعنى والوزن والقافية. بذلك، وضع الأساس لتقعيد النقد العربي وربطه بالمفاهيم البلاغية والمنطقية السائدة في عصره.
واصل قدامة توسيع نظريته من خلال محاولاته دمج النقد بالأصول المنطقية المستمدة من الفكر اليوناني، خاصة المنطق الأرسطي، وهو ما أضفى على النقد الأدبي طابعًا عقليًا بعيدًا عن الأحكام الانطباعية. تبنّى أسلوبًا علميًا في تحليل النصوص الشعرية، وركّز على العلاقة بين الشكل والمعنى كمدخل لتقييم جودة الشعر. قدّم تصورات نقدية حاول من خلالها تحديد مواطن الجمال والضعف في النص، وهو ما فتح المجال أمام النقاد اللاحقين لتطوير أدواتهم النقدية بناءً على هذا الإرث.
أثّر منهج قدامة بشكل واضح في التوجهات النقدية التي ظهرت بعده، فقد اعتمد كثير من النقاد على تصنيفاته وتحديداته كمرجع أولي في فهم الشعر وتحليله. رسّخ مكانته بوصفه أحد أوائل النقاد الذين سعوا إلى تحويل النقد إلى علم مستقل بذاته. وبهذا، استطاع أن يشكّل نقطة تحوّل في تاريخ النقد العربي، وأن يُمهّد لظهور رؤى نقدية أكثر تعقيدًا وتنوعًا في مراحل لاحقة، مما جعل حضوره مستمرًا في بنية التفكير النقدي العربي.
التأثير المباشر في النقّاد بعده مثل عبد القاهر الجرجاني
استمر تأثير قدامة بن جعفر في النقد العربي من خلال ما ظهر في أعمال النقاد اللاحقين، وفي مقدمتهم عبد القاهر الجرجاني، الذي يُعد من أبرز من تفاعلوا مع الإرث القدامي. ورث الجرجاني الرؤية المنهجية التي تبناها قدامة، لكنه أعاد إنتاجها ضمن نسق بلاغي أكثر عمقًا وتركيبًا. تابع الجرجاني فكرة أن الشعر صناعة، وأن عناصره تخضع لعملية تحليل دقيقة تكشف عن بنيته الجمالية. ورغم اختلاف المصطلحات بين الاثنين، إلا أن الروح المنهجية التي بدأها قدامة ظلّت حاضرة في تصور الجرجاني للنص الأدبي.
ارتكز الجرجاني في مشروعه النقدي على فكرة المعنى بوصفه محورًا أساسيًا في تقييم النص، وهي فكرة وجد لها جذورًا في كتابات قدامة، خاصة في حديثه عن العلاقة بين اللفظ والمعنى. كما طوّر الجرجاني مفاهيم بلاغية أكثر تعقيدًا مثل النظم والدلالة والسياق، لكنها انطلقت من المبدأ ذاته الذي رسّخه قدامة، وهو أن الشعر الجيد هو الذي يُقيم توازنًا دقيقًا بين المبنى والمعنى. شكّل هذا التفاعل بين قدامة والجرجاني حلقة مهمة في تطور النقد العربي من تحليل سطحي إلى قراءة متعمقة تُراعي العناصر الجمالية والدلالية للنص.
عبّرت أفكار الجرجاني عن امتداد طبيعي للأرضية التي وضعها قدامة، إذ استثمر الأول ما بدأه الثاني من تقعيد وتقسيم، وأضاف إليه تأملات جديدة تنتمي إلى علم المعاني والبيان. ومن خلال هذا التداخل، يمكن فهم كيف ساهم قدامة بن جعفر في توجيه مسار النقد الأدبي لاحقًا، وخصوصًا في مدرسته البلاغية التي مثّلها الجرجاني، ما يدل على أن أثره لم يكن محدودًا بزمنه، بل تجاوزه إلى أجيال من النقاد الذين وجدوا في مشروعه رؤية تأسيسية قابلة للتطوير.
الامتداد الفكري لنظرياته في النقد الحديث
تجلّت أفكار قدامة بن جعفر في مقاربات عدد من النقاد المعاصرين الذين حاولوا إعادة قراءة التراث النقدي العربي من منظور حديث. ظهرت ملامح هذا الامتداد من خلال الاهتمام بالتحليل البنيوي للنص، وهو ما كان قدامة قد مهّد له بطريقة غير مباشرة حين وضع معايير محددة لتحليل الشعر. تشابهت بعض مفاهيم النقد الحديث مع ما جاء به قدامة في تصوره لعناصر الشعر، حيث ركّز النقاد المحدثون أيضًا على البناء الفني والعلاقات الداخلية للنص، وهو ما يبرهن على استمرارية التأثير الفكري.
اعتمد عدد من الباحثين المعاصرين على رؤية قدامة في تقييمهم للنصوص الشعرية، من خلال التركيز على مبدأ الانسجام بين الشكل والمضمون، وهو ما يتقاطع مع مفاهيم حديثة مثل التماسك النصي والوحدة العضوية. كما أظهرت دراسات حديثة أن النقد العربي يمكن أن يُعيد إنتاج أدواته من خلال الرجوع إلى النماذج المؤسسة كقدامة، لا بهدف التقليد، بل بهدف تطوير تلك الأدوات ضمن سياقات معرفية جديدة. أثبت ذلك أن نظريات قدامة لا تزال تحتفظ بقدرتها على مواكبة متطلبات النقد المعاصر.
تمكّن فكر قدامة من العبور إلى مراحل نقدية لاحقة بسبب طبيعته المنهجية، ولأنها تقوم على أسس يمكن تأويلها وتطويرها وفق تطورات الفكر النقدي. ولذا، لم يكن غريبًا أن يجد الباحثون في تنظيراته مداخل متعددة لفهم الشعر من زاوية موضوعية. أصبحت بعض مفاهيمه جزءًا من المباحث الأكاديمية التي تزاوج بين التراث والمعاصرة، مما يكشف عن ديناميكية فكره وقدرته على البقاء ضمن دائرة الاهتمام النقدي الحديث، رغم التحولات الكبرى في مناهج النقد الأدبي.
حضور فكره في الجامعات والدراسات الأكاديمية المعاصرة
يحظى فكر قدامة بن جعفر بحضور واضح في المؤسسات الأكاديمية، سواء من خلال تضمينه في مناهج تدريس النقد العربي القديم، أو عبر البحوث الجامعية التي تتناوله بالتحليل والمقارنة. استمر اعتماد كتاب “نقد الشعر” كمرجع رئيسي في المقررات الدراسية التي تهتم بجذور النظرية النقدية العربية، حيث يُدرّس لطلبة اللغة العربية بوصفه نموذجًا مبكرًا للتنظير الأدبي المنهجي. شكّل هذا الحضور الأكاديمي وسيلة لضمان استمرارية الفكر القدامي ضمن المناهج المعاصرة.
تُظهر الرسائل الجامعية في مختلف الجامعات العربية اهتمامًا بتحليل منهج قدامة النقدي، من خلال دراسات تركز على المصطلح والأسلوب والوظيفة الجمالية للنص كما فهمها في عصره. ركّزت العديد من البحوث على إعادة قراءة مصطلحاته وتحليل أدواته النقدية في ضوء مفاهيم حديثة، ما يبرهن على قدرة فكره على التفاعل مع قضايا العصر رغم الفارق الزمني. كما عبّرت هذه الدراسات عن وعي متزايد بأهمية الربط بين التراث النقدي والمنهجيات المعاصرة في الدراسة الأكاديمية.
يعكس هذا التفاعل بين فكر قدامة والدراسات الجامعية المعاصرة توجهًا عامًا نحو إعادة الاعتبار للموروث النقدي العربي، بوصفه موردًا غنيًا يمكن أن يُسهم في تطوير المعرفة الأدبية. أصبح فكره جزءًا من التكوين العلمي للباحثين الجدد، وهو ما يعزّز حضوره كمفكر نقدي مؤسس. وبهذا، يتضح أن قدامة بن جعفر لم يكن مجرد ناقد قديم، بل صاحب مشروع نقدي عميق ما زال يُعيد تشكيل فهم النقاد والطلاب لطبيعة النص الشعري وطرق تحليله داخل الوسط الأكاديمي الحديث.
مكانة قدامة بن جعفر في تاريخ النقد الأدبي العربي
تميّز قدامة بن جعفر بمكانة رفيعة في تاريخ النقد الأدبي العربي، حيث ساهم في إرساء قواعد جديدة للفكر النقدي خلال العصر العباسي، وأحدث تحولًا في النظر إلى الشعر بوصفه مجالًا يستحق الدراسة والتحليل وفق منهج علمي. وقد تبنّى هذا المفكر منهجًا دقيقًا في تحليل الشعر، مبتعدًا عن الأساليب الانطباعية التي كانت سائدة قبله، وسعى إلى تقديم تعريف جامع للشعر يربط بين عناصره الفنية والدلالية. ومن خلال كتابه “نقد الشعر”، تمكّن من صياغة تصور نقدي متكامل يربط بين الشكل والمضمون، مما أسهم في تأسيس خطاب نقدي عربي يعتمد على المنطق والتفسير لا على الذوق الفردي وحده.
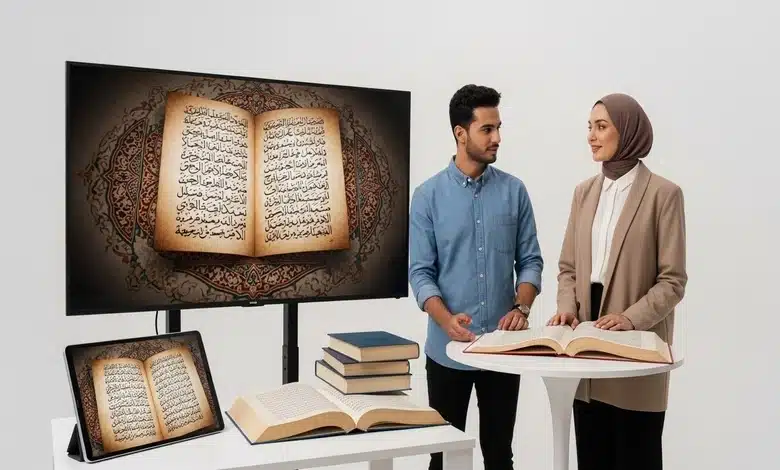
أظهر قدامة بن جعفر وعيًا استثنائيًا بأهمية تصنيف الشعر ومقاربته بطريقة منهجية، حيث عمل على تحديد أغراضه ومكوناته، وبيّن العلاقة بين المعنى واللفظ، مشددًا على ضرورة الانسجام بينهما لبلوغ الجمالية الشعرية. كما استطاع أن يؤسس لمفاهيم نقدية جديدة، من أبرزها فكرة أن جودة الشعر لا تتوقف على أخلاقيات المعنى بل على مدى انسجام العناصر الفنية معًا. وبهذا الطرح، خالف بعض الاتجاهات التقليدية التي كانت تقيّم الشعر بناءً على معاييره الأخلاقية فقط، ممهدًا الطريق أمام مقاربات أكثر حرية وشمولًا.
عززت طروحات قدامة من انتقال النقد العربي من التذوق الشخصي إلى التعليل والتحليل، ما جعله واحدًا من أوائل المفكرين الذين تعاملوا مع النص الأدبي بوصفه بنية قابلة للفهم والتفكيك. وقد استمر أثره في المدارس النقدية التي جاءت بعده، والتي تبنّت أساليبه المنهجية في تحليل النصوص. لذلك، لا يمكن الحديث عن تطور النقد العربي دون التوقف عند إنجازاته، التي وضعت اللبنات الأولى لنظرية نقدية متكاملة في الثقافة العربية الإسلامية، ومنحته مكانة ريادية لا تضاهى في تاريخ الأدب العربي.
لماذا يُعدّ قدامة نقطة التحول في مسار النقد العربي؟
جسّد قدامة بن جعفر نقطة التحول الكبرى في مسار النقد العربي من خلال نقله لهذا الفن من مجال الانطباع والتذوق إلى مجال التحليل والتنظير المنهجي. وقد انطلقت رؤيته من تحديد الشعر ككيان لغوي منضبط بالوزن والقافية والدلالة، ما يعني دخوله دائرة العلم لا مجرد الفن. وقد أتاحت هذه النظرة الجديدة فرصة للنقد لأن يتحوّل من رصد جمالي إلى تحليل وظيفي، يتناول البنية والأسلوب والدلالة. لذلك، شكّل مشروعه النقدي منعطفًا أساسيًا في مسار تطور الفكر الأدبي العربي.
لم يتوقف تأثير قدامة عند تعريفه للشعر فقط، بل شمل أيضًا تقسيمه المنهجي للأغراض الشعرية، وهي خطوة أساسية أدخلت التصنيف كعنصر في المقاربة النقدية. فقد اعتبر أن لكل غرض شعري سماته الخاصة التي ينبغي أن تحكم تقييمه، سواء أكان مدحًا أو هجاءً أو وصفًا. وقد منح هذا التصنيف إمكانية جديدة لفهم الشعر بناءً على غاياته ووظائفه، بدلًا من الاكتفاء بالحكم عليه وفق معيار موحد. هذا التوجه أسس لفكرة تنوّع المعايير النقدية باختلاف السياق الشعري.
كما اتضح من كتاباته اعترافه بحرية التعبير في الشعر، حيث لم يحكم على جودة النص من خلال أخلاقية المعنى، بل من خلال توافق عناصره الفنية. وهذا التحرر من القيود الأخلاقية التي كبّلت النقد في فترات سابقة ساعد على بروز نظرة أكثر موضوعية، تعترف بحقوق النص في تجاوز الأعراف مادام يحقق غايته الجمالية. ومن هنا يتضح أن قدامة بن جعفر لم يكن مجرد ناقد تقني، بل مصلح نقدي أعاد تشكيل النظرة إلى الأدب وأسس لبداية جديدة في التعامل مع النص الشعري.
تقييم إسهاماته مقارنة بتيارات النقد الغربي الكلاسيكي
يبرز تأثير قدامة بن جعفر أكثر وضوحًا عند مقارنته بتيارات النقد الغربي الكلاسيكي، وخصوصًا ما وصل من أفكار أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان. فقد تبنّى قدامة أدوات تحليلية مشابهة من حيث التركيز على البنية الداخلية للنص، إلا أنه حافظ على خصوصية السياق العربي، وطبّق هذه الأدوات على الشعر العربي بلغة تنبع من تراثه ومفاهيمه. ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار جهوده نوعًا من التوليف بين المفاهيم الفلسفية الكلاسيكية والذوق الأدبي العربي، مما أفرز مقاربة نقدية فريدة تجمع بين العقل والذوق.
استفاد قدامة من مفاهيم منطقية لتحليل العلاقة بين المعنى واللفظ، وهي ثنائية ظلت مركزية في كتاباته، في مقابل تركيز النقد الغربي الكلاسيكي على مفاهيم مثل المحاكاة والتطهير. وبالرغم من هذا الاختلاف، فقد التقى المنهجان في محاولتهما تفكيك النص الأدبي ودراسة عناصره بموضوعية. إلا أن قدامة أولى أهمية خاصة للجانب اللغوي، وركّز على البنية الصوتية والمعجمية، وذلك انطلاقًا من الطابع اللغوي العميق للثقافة العربية مقارنة بالطابع المسرحي في الثقافة اليونانية.
تكمن فرادة إسهامات قدامة في أنه لم يكتف بمحاكاة النموذج اليوناني، بل أعاد صياغته بما يتناسب مع البيئة الثقافية الإسلامية، فكانت رؤيته أقرب إلى النقد التأصيلي الذي ينطلق من الداخل لا من الخارج. وقد أرسى من خلال ذلك تصورًا نقديًا متكاملًا يستجيب لمتطلبات النص العربي، ويجعل من النقد أداة لإعادة فهم الشعر لا مجرد تكرار لأفكار مستوردة. بذلك، تبقى مساهماته في هذا المجال علامة فارقة، تعكس وعيه بضرورة تأسيس خطاب نقدي أصيل، يقف على مسافة واحدة من الإبداع والتقليد.
استمرارية فكره في الموروث النقدي العربي والإسلامي
اتّضح أثر فكر قدامة بن جعفر في الموروث النقدي العربي والإسلامي من خلال استمرار المفاهيم التي وضعها في كتاباته، حيث تحوّلت إلى مرجعيات أساسية للنقاد الذين جاؤوا بعده. فقد اعتمد كثير من النقاد على طروحاته في تحليل الشعر من حيث المعنى واللفظ والأغراض، واستندوا إلى تصنيفاته كأساس لبناء دراساتهم النقدية. وهذا الاستلهام لا يعني مجرد تكرار بل هو امتداد طبيعي لتأسيسه أول نظرية نقدية عربية تعتمد على التحليل والتفسير.
انعكست هذه الاستمرارية أيضًا في تحول النقد العربي من التلقائية إلى التخطيط المنهجي، حيث غدا الناقد أكثر وعيًا بالمعايير الفنية التي تحدد جودة النص. ولم يكن هذا التحول وليد لحظة معزولة، بل جاء نتيجة لتراكم فكري بدأت ملامحه مع قدامة، الذي أوجد لغة نقدية دقيقة، تستند إلى المفهوم والحد والتعليل. وقد أدّت هذه اللغة إلى نشوء تيارات نقدية جديدة في العصور اللاحقة، امتد تأثيرها حتى العصر الحديث، مما يؤكد أن فكره لم يتوقف عند حدود عصره، بل كان مؤسسًا لحركة فكرية طويلة الأمد.
ساهمت أفكار قدامة في تشكيل وعي نقدي جديد، حيث لم يعد الشعر يُنظر إليه على أنه مجرد تعبير عن العاطفة أو الجمال، بل أصبح ميدانًا للتفكير والتأمل. وقد أفضى هذا التحول إلى نشوء حوارات نقدية معمقة في الثقافة العربية، تناولت مفاهيم مثل جودة المعنى وتماسك اللفظ وحرية الشكل. وهكذا، يمكن القول إن فكر قدامة بن جعفر ظل حيًا في ضمير النقد العربي، وأسهم في تأسيس تقاليد نقدية متجددة، تجاوزت حدود الزمن، واستمرت في صياغة أفق جديد للتفاعل مع النص الأدبي داخل الموروث العربي والإسلامي.
ما الجديد الذي أضافه قدامة لتعريف الشعر؟
قدّم تعريفًا إجرائيًا للشعر يضمّ الوزن والقافية والدلالة في منظومة واحدة قابلة للفحص، لا وصفًا إنشائيًا. حدّد عناصر التقييم وأدخل فكرة الانسجام الداخلي بين الشكل والمضمون، فصار التعريف مفتاحًا لآليات نقدٍ موضوعي تُقاس بها الجودة وتُشخَّص مواطن الخلل.
كيف ربط بين البلاغة والمنطق في الممارسة النقدية؟
عامل البلاغة كأداة تقويم لا زينة، وطبّق مفاهيم منطقية كالتعريف والتقسيم لفرز الظواهر الأسلوبية. جعل معيار البلاغة خدمتها للمعنى، فميّز بين المحسّن المنتج والدخيل، وأقام حكمه على التناسب والاتساق، لا على الإعجاب اللحظي أو الذوق الفردي.
ما أثر مشروعه في النقاد اللاحقين والدرس الأكاديمي؟
هيّأ أرضيةً اعتمدها اللاحقون في بلورة مفاهيم النظم والوحدة العضوية والتماسك النصّي. دخلت كتبه مقررات الجامعات، وصار منهجه نموذجًا لتحويل الذائقة إلى أدوات تحليل، فاستمر حضوره في النقد الحديث بوصفه مرجعًا للتأصيل ورافعة للتطوير.
وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن مشروع قدامة بن جعفر النقدي نقل الثقافة العربية من الانطباع إلى البرهنة، فوحّد مقاييس الحكم على الشعر حول انسجام اللفظ والمعنى والإيقاع المُعلن عنه. ثبّت مرجعية التعريف والتصنيف والتقويم، وفتح للنقاد مسارًا علميًّا يستوعب الجمال بوظيفته ومعناه، فظلّ أثره ممتدًا في الدرس الأكاديمي والممارسة النقدية المعاصرة.
تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى
جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.
ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.